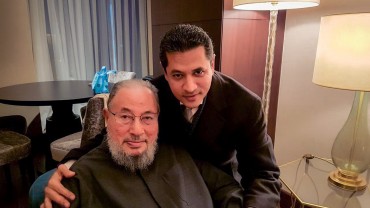صفحة من مذكرات سماحة الشيخ:
وكان الزواج من أهم الأحداث الاجتماعيَّة في القرية، وكانت الأسرة هي الَّتي تُرشِّح العروس للفتى، وكثيرًا ما يكتفي بترشيح أهله، وقلما كان يطلب الرؤية. ولم يكن عند النَّاس فقهٌ كاف بأن رؤية الخاطب لمخطوبته مطلوبة شرعًا. وأحيانًا تُدبَّر له رؤية الفتاة دون أن تشعر، وأحيانًا أخرى يكون قد رأى هو الفتاة، فيعرض على أهله أن يخطبوها له.
وكان العَرِيس «أو المِعْرِسْ»، كما يُسمِّيه أهل الخليج، يُقَدِّم المهر، ويساعد في شراء الجهاز، ثمَّ يكتب الجهاز في قائمة باسم العروس، فهو ملكها، تطالب به عند الانفصال إذا قدر الله ذلك.
ولم تكن عادة «الشبكة» معروفة في الرِّيف في صباي، ولا أدري متى عُرفت؟ ولا من أين نُقلت؟ فهي عادة مستوردة. فقد زادت في أمر الزواج عقدة ليس لها لزوم، فأصبح هناك حفل للشبكة، وحفل لعقد القران، وحفل للزفاف، وكل هذه أعباء تعوق الزواج، وتعطل مسيرته وتؤخر الشباب بعض الوقت.
وكان أهل القرية حريصين على أن يزوجوا أبناءهم مُبَكِّرين، حرصًا على أن يحصنوهم من الانحراف أو التفكير فيه من ناحية، وأن يحفظوا نصف دينهم من ناحية ثانية، وأن ينجبوا ذريَّتهم في وقت مُبَكِّر. وكان يساعدهم على هذا أن التعليم كان محدودًا، ولم يكن هناك عائق أمام الفتى والفتاة من الزواج. وخصوصًا أنَّ الزوج كان يبقى في بيت العائلة، ويكفي أن تُهَيَّأ له غرفة له ولزوجه، في البيت الكبير، الَّذي تشرف عليه غالبًا أم الأبناء، ورُبَّما جَدَّتهم.
وكانت السنُّ القانونيَّة للزواج (16) سنة، ومع هذا كانوا كثيرًا ما يزوجون البنت أقل من (16) سنة بطريقة «التسنين الطِّبِّي». وكانوا حراصًا على المصاهرة إلى الأسر الأصيلة والكريمة، ويقولون في أمثالهم: «دُورْ مع الأيَّام إذا دارت، وخدْ بنت الأَمَارة ولو بارت». ويحذرون من زواج المرأة السيِّئة لأجل مالها، ويقول مَثَلُهم: «لا تأخذ القرد على كثرة ماله، يروح المال ويبقى القرد على حاله». وإذا تزوج رجل لئيم من امرأة لئيمة، قالوا: «زوَّجوها له، ما لها إلا له». أو قالوا: «زوجوا مِشْكاح لرِيمَة، ما على الاتنين قيمة».
وكان لهم عادات سيئة توارثها الأهالي في ليلة الزفاف، حيث يحضُر بعض النساء الكبيرات والقريبات من الزوج والزوجة، ويفضُّ الزوج بكارتها أمامهن، ويسيل دم البكارة متدفِّقًا على شاش أبيض، فتنطلق الزغاريد بعدها، ويُخرج بالشاش الملون باللون الأحمر، وتغنِّي النساء والبنات، فرحًا بثبوت طهارة البنت وعذريتها وشرفها، وأنها لم يمسسها رجل من قبل. ومن الأغاني الَّتي كانوا يرددونها: «قولوا لأبيها يقوم يتعشى!» يعني: أن الرجل كان ممتنعًا عن الأكل حتَّى تثبت طهارة ابنته، ومن حقه بعد ذلك أن يتناول عشاءه، ويمارس حياته.
وقد أنكر العلماء هذه العادات القبيحة، وأكَّدوا أنَّها محرَّمة، ولا يجوز لامرأة أن تنظر إلى عورة امرأة، وأن هذا ينبغي أن يكون سرًّا بين المرء وزوجه. وكان بعض الرجال يحس بالعجز الجنسِي ليلة الزفاف، لعلَّ ذلك لعوامل نفسيَّة، مصدرها الهيبة والتخوف وعدم الثقة بالنفس، ويقول النَّاس عنه: إنَّه مربوط، ويفسرون ذلك بأنه مسحور، أو معمول له عمل. ويركض وراء السحرة والدجَّالين كي يفكوا سحره.
وكانوا يحبُّون كثرة النسل، ويؤمنون بأنه الهدف الأوَّل من الزواج، والله تعالى يقول: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل:72]. ويذكرهم المأذون في خطبة عقد القران دائمًا بالحديث القائل: «تزوَّجوا الودود الولود؛ فإنِّي مكاثرٌ بكم الأمم». ولم تكن فكرة تحديد النسل أو تنظيمه واردة في ذلك الوقت، وكلُّهم يرون الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا: نعمة وبركة، وهبة من الله: {يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا} [الشورى:49، 50].
وكان على الزوجة أن تضع وليدها، وتتركه لحماتها أمِّ زوجها، فهي الَّتي تتولَّى في الغالب تربيته، ما عليها إلَّا أن ترضعه وقت رضعته، وعلى الجَدَّة أن تراعيه وتتعهَّده، ولم يكن الأولاد يتطلَّبون في ذلك الحين من المتابعة والمعاناة ما يتطلَّبه أولاد اليوم، فلم تكن هناك مشكلة في الإنجاب.
ومن تأخَّرت عن الإنجاب يُصيبها القلق الشديد، ويصيب أهلها - وأمُّها على وجه الخصوص - كما يقلق أهل الزوج - وخصوصًا أمّه - وتبدأ المرأة في البحث عن الخلف، والجري وراء الأوهام والخرافات عند الكهنة والدجالين، الَّذين يتقنون الكهانة، أو يكتبون الحجاب، أو يصفون الوصفات الَّتي لا تقوم على علم ولا هدى ولا كتاب منير. والنساء يصدِّقن، ويبذلن المال لهؤلاء، ولا يجدن ثمرة لهذه التُرَّهات.
وكان الزواج في غالبه موفَّقًا، يقوم على السكينة والمودَّة والرحمة، وهي دعائم الحياة الزوجيَّة، كما صورها القرآن: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم:21]. وكما قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة:187]. وهذا ما لم يتدخَّل شياطين الإنس في إفساد العلاقة بين الزوجين لسببٍ أو آخر. وكثيرًا ما يكون ذلك بسبب تدخُّل أهل الزوج أو أهل الزوجة، أو تدخُّل أهل السوء.
وكان الأغلب في علاقات المصاهرة أن تحبَّ الحماة زوجَ ابنتها، ولا سيَّما إذا كان زواجها منه برضاها ومباركتها. ولم تكن الشكوى من الحماة كما يشكو أكثر الأزواج في عصرنا، حتَّى أصبحت السخرية من الحماة وتأليف النكت عليها أمرًا شائعًا. بل كانت الحماة توفِّق الأكلات الطيِّبة لحين زيارة زوج ابنتها، وهذا سرُّ قول النَّاس عادة إذا جاء المرء وقت حضور الطعام الطيِّب: «حماتك تحبك». ومعنى أنَّها تُحِبُّه: أنَّها تُهيِّئ له أطيب الطعام في حالة قدومه، وكأنَّما وقع مصادفة، وهو مقصود منها.
أما المشكلة الَّتي كانت الشكوى منها باستمرار، فهي علاقة الحماة مع زوجة الابن، فأكثر الحموات - أمَّهات الأزواج - لا يُطقن زوجات الأبناء، ويشعُرْنَ كأنَّما خطفْنَهم منهنَّ، وخصوصًا إذا كان الابن وحيدًا، إلَّا من رحم ربُّك من الحموات، وقليلٌ ما هنَّ. ولقد سمعتُ من زوجة خالي الأولى مثلًا يقول: «إذا كانت الغلة قد التِّبْن، تكون الحماة تحب امرأة الابن!»، ومثل آخر قالته، وهو: «حماتي مَكِيرة وأنا أمكر منها، تعد اللحمة وأنا أقطَّع منها!».
وكان الأصل في الزواج: الاستقرار، وعدم الطلاق. فقد كان النَّاس يكرهون الطلاق، ويرَوْنه مصيبة، ولا يحب أهل المرأة أن تُطلَّق، وتقول بعض العائلات: ليس عندنا بنات تُطلَّق. وأحيانًا تأتي المرأة غاضبة من زوجها إلى بيت أبيها، فيأخذها أبوها، أو يأمر شقيقها أن يأخذها ليرُدَّها إلى بيت زوجها. وإذا كان الزوج أصيلًا قدَّر هذه الفعلة حقَّ قدرها، وحاول أن يصلح ما بينه وبين امرأته، كرامةً لأهلها. أمَّا الخسيس، فلا يزيده هذا إلَّا إصرارًا على إيذائها والتعدِّي عليها، كما قال أبو الطيِّب: إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ وإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدا
وقد يتدخَّل أهل الخير لإصلاح ذات البَيْن، فيُوَفِّقهم الله تعالى للإصلاح، وقد تبوء المحاولات بالإخفاق، وينتهي الأمر بالطلاق، وهو أبغض الحلال إلى الله. وكثيرًا ما يحدث الطلاق، في حين لا يريده أحد من الزوجين، وذلك في «الطلاقات» الَّتي يوقعها «الفقه التقليدي» الموروث، وليس لتعذُّر الوفاق بين الزوجين، بل لحدوث حالةِ غضبٍ عند الزوج أفقده السيطرة على نفسه، فصدر منه الطلاق دون أن يريده، مع أنَّ هذه الحالة هي الَّتي جاء فيها الحديث: «لا طلاقَ ولا عِتَاقَ في إغْلاق».
ومثل ذلك: «أيمان الطلاق»، أي الطلاق الَّذي يُراد به الحمل على شيء أو المنع منه، كمعظم أنواع الطلاق الَّتي تحدث من كثير من الناس، حين يريد أن يحمل نفسه على شيء، أو يمنعها منه، أو يحمل زوجته أو صاحبه على شيء، أو يمنعها منه. مثل: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا. ولا يفعله، أو لأتركنَّ كذا. ولا يتركه.
وربما يكون هذا بينه وبين شخص آخر، وزوجته لا تدري بذلك، ولا علاقة لها به، وربَّما كانت علاقتهما سمنًا على عسل، فإذا هو يحلف ألَّا يبيع سلعته إلَّا بسبعين، ثمَّ يبيعها بستِّين، ثمَّ يعود إلى امرأته فيجدها مُطَلَّقة، وَفْق ما يقوله له المشايخ، وكثيرًا ما يكون هذا الطلاق بالثلاثة، فتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره.
وهنا يبحث النَّاس عن «المحلِّل»، وهو الَّذي يتزوج المرأة لا ليبني بيتًا، أو يحقق المقاصد الشرعيَّة من الزواج، بل لمجرد أن يحللها للزوج المطلق، وهو الَّذي سمَّاه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له: «التَّيْس المستعار»، ولعن المحلِّل والمحلَّل له.
وكثيرًا ما دُمِّرت أُسر وخربت بيوت، وشُتِّت أطفال، نتيجة هذا الفقه الَّذي توسَّع في إيقاع الطلاق، فأوقع الطلاق البِدْعي والسني، وأوقعه إذا أريد به اليمين، وأوقعه في حالة الغضب والرضا، وأوقعه إذا كان له وطر، أم لم يكن له وطر.
وكان أكثر النَّاس يكتفي بزوجة واحدة، ومع هذا كان تعدد الزوجات شائعًا، ففي حارتنا - وهي صغيرة - كان هناك خمسة لهم زوجتان. وكان جارنا الأدنى الحاج محمَّد عيسى، له زوجتان، وكأنهما أختان أو صديقتان. على حين كان الآخرون في حالة خصام، يهدأ حينًا، ويثور حينًا آخر. وأحيانًا ينتهي بتقريب واحدة وتعليق أخرى، وهو ما نهى عنه القرآن حين قال: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء:129]. والْمُعلَّقة: المرأة الَّتي لا هي مزوَّجة، ولا هي مطلَّقة. والآية تعني: أن بعض الميل مغتفر، وخصوصًا في العواطف والاشتهاء، ولكنَّ المحرَّم هو الميل كل الميل.
وكانت الأسرة في غالب أمرها مترابطة بين أفرادها، فالأولاد يبرُّون آباءهم وأمَّهاتهم، ويرون أنَّ رضا الله تعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تعالى في سُخط الوالدين، وإذا وُفِّق أحدهم في عمله، وبورك له في رزقه وفي أولاده، يقول: هذا ببركة رضا الوالدين، ودعاء الوالدين.
وكان الآباء والأمَّهات يًحِنُّون على أولادهم بنين أو بنات، وكان قليل من النَّاس يفضِّلون الأبناء على البنات، ولا سيَّما في الميراث، جاهلين أنَّ ذلك من الكبائر، كأنَّما هو استدراك على الله تعالى في حكمه، وقد قال تعالى في آية المواريث: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:11].
وكانت ظاهرة العقوق للآباء والأمهات نادرة، ولكنَّها كانت موجودة، وهي تُمَثِّل الشذوذ الَّذي يثبت القاعدة ولا ينفيها. وممَّا يتناقله أهل القرية وشاهدته بعيني: قصَّة الشيخ بدوي، الَّذي كان يمتلك عددًا من الأفدنة، وكان رجلًا ميسور الحال، وكان له زوجتان، وكان ابنه الأكبر من زوجته الأولى قد لعب بعقله، وأثَّر عليه، حتَّى كتب له أرضه كلَّها، وحرم منها أولاده من زوجته الأخرى، وهم أكثر عددًا، وأشدُّ حاجة.
والمهم أن الابن الَّذي كُتب له الأرض أو بيعت له صوريًّا، وأصبح مالكًا لها، تنكَّر لأبيه بعد ذلك، وأمسى الرجل صفر اليدين، يفتقر إلى من يحسن إليه، ولم يجد من يمدُّ له يد الإحسان والمعونة غيرَ أبنائه الَّذين ظلمهم وحرمهم من حقِّهم. وكان هذا درسًا لا يُنسى، في تجاوز العدل الَّذي فرضه الله على عباده، وأمرهم أن يعطوا كلَّ ذي حقٍّ حقِّه.
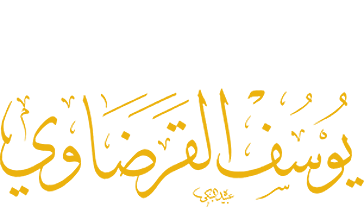
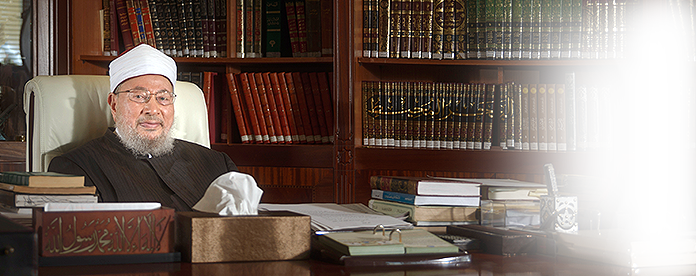
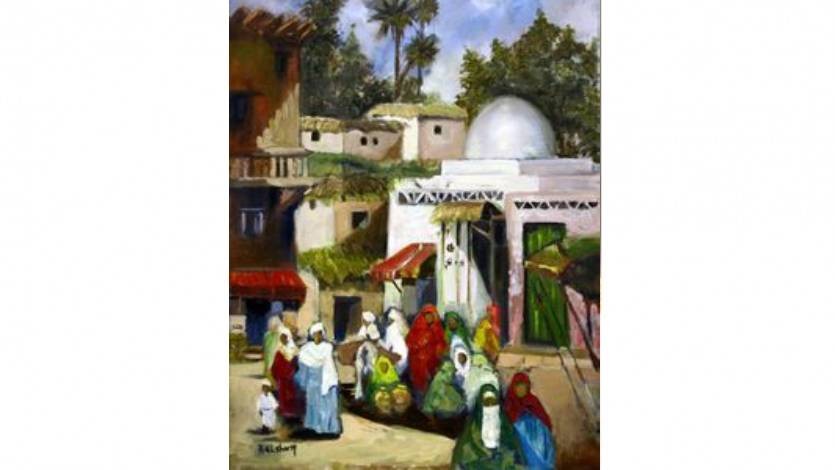
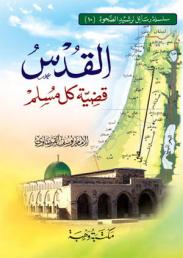 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟ 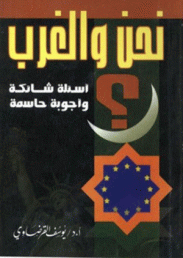 نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد