د. يوسف القرضاوي
هو كتاب الإسلام، فهو المصدر الأول لهذا الدين يؤْخذ منه أوَّل ما يؤْخذ قواعد الدين ومقاصده وكلياته، وتأتي السنة المصدر الثاني؛ لتبيِّن وتفسِّر، ولكن الأساس في كتاب الله عزَّ وجلَّ، ولهذا قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (النحل:89) لكلِّ شيء في أمور الدين، أما أمور الدنيا فقد تُركت لنا، وبحسب القرآن أن يشير إلى ما يهدي إليها فنحن أعلم بأمور دنيانا، أمَّا كليَّات الدِّين وقواعدُه، ومبادئه وأساسياتُه؛ فهي في القرآن الكريم.
ومن خصائص القرآن الكريم أيضًا: أنَّه كتابٌ مُيَسَّر، قال تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} (17، 22، 40). وقال عزَّ وجلَّ: {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (الدخان:58). فهو مُيسَّر للفهم، ومُيسَّر للحفظ، لأنَّه كتاب مبين: {تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} (يوسف:1، الشعراء والقصص:2). فهو بيِّن في نفسه، مُبيِّن للحقائق، كاشف للناس عمَّا يوصلهم إلى سعادة الدنيا والآخرة.
ومن خصائصه: أنه كتاب معجِز، فهو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى وآيته العظمى.
لم يتحدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأيِّ آية من الآيات؛ مع أنَّ الله سبحانه وتعالى أظهر على يديه من الآيات والخوارق الكونيَّة الكثير، كما أظهر على أيدي الأنبياء والرسل السابقين.
آياتٌ كثيرة ألفت فيها كتب تسمَّى «دلائل النبوَّة» عن الآيات والمعجزات والخوارق للعادات والإنباء عن الغيوب، كتكثير الطعام القليل بين يديه صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، وحنين الجذع إليه، وتسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر له، والإسراء والمعراج وأشياء كثيرة جدًّا، ومع هذا لم يتحدَّ إلَّا بالقرآن، فهو الآيةُ الَّتي تحدَّى بها العرب أن يأتوا بمثله: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ} (الطور:34). أو بعَشر سور مثله: {فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} (هود:13). أو بسورة من مثله: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (البقرة:23).
تحداهم، وقال: إنكم لن تفعلوا: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (البقرة:34). فغُلبوا وانقطعوا وحقَّت عليهم كلمة الله: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} (الإسراء:88).
هذا هو القرآن الكريم الَّذي أكرم الله به أمَّة الإسلام، وأعطاها هذا الدستور الخالد، وهذا المنهاج الشامل الَّذي أخرجها من الظلمات إلى النور، والذي كان حبل النجاة للعرب، فأخرجهم من الجاهليَّة إلى الإسلام، ومن الشِّرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الجهل إلى العلم، ومن البداوة إلى الحضارة، قال تعالى: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (المائدة:15، 16).
هذا الكتاب فسَّره المسلمون وخدموه، كلٌّ في مجال اختصاصه، فمنهم من خدمه بالحفظ، ومنهم من خدمه بالكتابة، ومنهم من خدمه بالقراءة، ومنهم من خدمه بالتفسير، ومنهم من خدمه باستنْباط الأحكام من آياته، وذلك منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا.
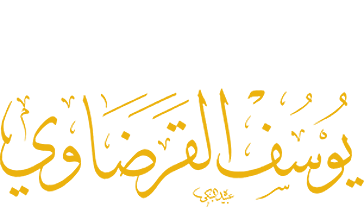


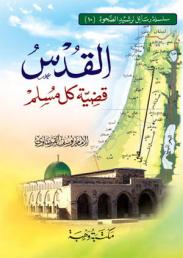 القدس قضية كل مسلم
القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟
درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟ 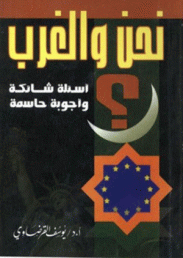 نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة
نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد
فقه الجهاد 






